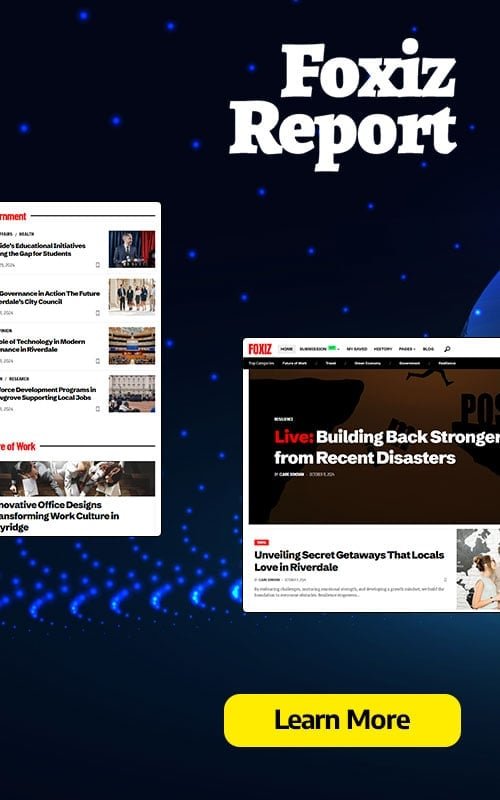لا يهمّني في هذا المقال اسم الممثل العربي الذي غيّر دينه، ولا قرارُه الشخصي، ولا الديانة التي انتقل منها أو إليها. فهذه حياته، وهذا خياره، وهذا حقّه الطبيعي الذي لا يحتاج إذناً من أحد. ما يهمّني، وما يستحق النقاش الحقيقي، هو حجم ونوعية التعليقات التي اجتاحت منصّات التواصل من جمهور عربي بدا وكأنه وجد فرصة ذهبية للتنفيس عن احتقاناته المزمنة.
المفاجأة ليست في اختلاف الآراء فهذا طبيعي بل في حدة الهجوم، عنف اللغة، وانشغال الناس بما لا يمسّ حياتهم من قريب أو بعيد. تحول جزء كبير من الجمهور إلى قضاة وعلماء ومحققين، لا وظيفة لهم إلا تصنيف البشر وتوزيع صكوك النجاة والهلاك.
واللافت أكثر أن غالبية هؤلاء المتحمسين للقتال الإلكتروني ينتمون إلى دول تنهشها الأزمات الاقتصادية، وتخنقها البطالة، وتنهار فيها الخدمات، ويغيب فيها الاستقرار السياسي والعسكري. شعوب تعيش في واقع قاسٍ، لكنّها وبلا أي مفارقة لا تبدي الحماسة نفسها تجاه ما يمسّ حياتها اليومية، كفساد مسؤول، أو تدهور تعليم، أو غياب أمن، أو انهيار عملة.
من خلف شاشات صغيرة، يثور الكثيرون على خيارات فنان…
لكنهم لا يثورون على واقعهم.
يُهاجمون ديانة الآخر الجديدة كأن مصير الكون متوقف على هذا التحوّل، ويهاجمون ديانته السابقة كأنهم يملكون مفاتيح السماء. يتصرفون وكأن تغيير دين شخص ما تهديد وجودي لهم، بينما التهديدات الحقيقية من فقر، وفساد، وتراجع تنموي تقف أمامهم يومياً، ومع ذلك لا تتحرك فيهم شعرة.
هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها أصبحت أوضح في عصر المنصّات. فقد تحوّل جزء من الجمهور العربي إلى جمهور يفضّل المعارك الوهمية على مواجهة الواقع، جمهور يجد في نقاشات الهوية والدين والفضائح ملاذاً من الإحباط، ومهرباً من الشعور بالعجز.
لكن الحقيقة البسيطة التي يرفض كثيرون الاعتراف بها هي:
الحياة الشخصية للمشاهير لن تُصلح مدارسنا، ولن تخفض الأسعار، ولن توقف الحروب، ولن تخلق فرص عمل.
المعضلة ليست في الممثل الذي غيّر دينه، بل في الجمهور الذي لم يغيّر شيئاً في حياته منذ سنوات، ولا يريد أن يغيّر.
المشكلة ليست في شخص يبحث عن معنى جديد، بل في مجتمعات فقدت معنى الفعل والتغيير، ووجدت في الصراخ الافتراضي علاجاً مؤقتاً لعجز طويل.
ربما آن الأوان أن نطرح سؤالاً مباشرًا ومحرجًا:
لماذا نثور على خيارات الآخرين، ولا نثور على واقعنا؟